تركيا وفتح ثغرات المحيط
الإقليمي والعالم
ـــــــــــــــــــــــ
(أمير سعيد)
ــــــــ
9 / 5 / 1436 هــ
28 / 2 / 2015 م
ــــــــــــ
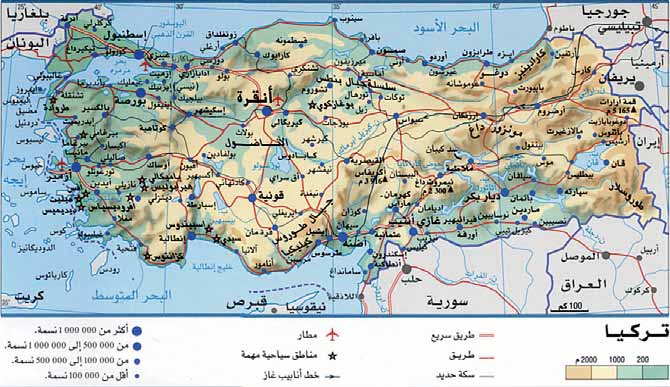
إذا كان المؤرخون قد خلصوا خلال دراستهم للدولة العثمانية العريقة إلى أسباب جوهرية أدت إلى زوالها قبل مئة عام؛ فإن إستراتيجيي الدولة التركية اليوم قد وضعوا كل تلك الأسباب على طاولتهم، ورسموا سياسة جديدة تسير بهم من خط النهاية إلى البداية.
كانوا إذن واقعيين حينما تجنبوا الوقوف على خط البداية ذاته لاستحالة إعادة تلك الدورة في اتجاهها الأصلي مرة أخرى؛ فالمناخ الذي نشأت فيه الدولة العثمانية يستحيل تكراره أو توفير ملابساته، لكن مناخ انهيار الدولة ربما أشبه في بعض ملامحه الأجواء التي أفلس فيها النظام العلماني، وسلم دفة الحكومة والبرلمان بنهاية عهد بولنت أجاويد إلى حكومة العدالة والتنمية؛ فعمدوا إلى كل أسباب انهيار تلك الدولة الممتدة لنحو ستة قرون ساعين إلى إدارة عقرب الزمن عكسيًا، وبنوا سياستهم على عكس كل عوامل وأسباب انهيار الدولة العثمانية التي كسرت ظهرها، مستفيدين في تجربتهم من إفلاس القوى العلمانية في إدارة شؤون البلاد وإخفاقها على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية.
أشبهت هذه اللحظة تلك، فلقد جاء هرتزل يعرض على السلطان عبدالحميد قطعًا من الذهب في وقت كانت الخلافة ترزح تحت ديون ثقيلة لدول «الاستعمار»، وكان العرض مغريًا بعض الشيء؛ فربما يفكر بعض الساسة في ظرف كهذا أن الذهب يمكنه أن ينقذ دولة هرمت وهمت بأن تغادر الحياة، وما كان له أن يفعل، إلا أنه يمكن أن يجدي في دولة فتية ما زالت تخطو خطوات الشباب الأولى كدولة تركيا/ العدالة؛ حيث وضعت برامج محكمة توقف نزيف الفساد، وتوظف المال في محله، وتقفز بمعدلات التنمية، وقد كان؛ فصار الآن الناتج المحلي لتركيا يفوق نواتج أكبر ثلاث دولة نفطية في الخليج العربي، وإذا كانت المؤامرات والقوى الخفية والماسونية قد فتكت بالداخل العثماني؛ فإن إدارة أردوغان عازمة على ملاحقة كل عناصر «الدولة العميقة» مهما تسربلوا بالأمن القومي أو التحفوا بأردية الإخلاص والتفاني، وإذا كانت جمعية الاتحاد والترقي قد اخترقت مؤسسات الدولة السيادية لاسيما الجيش، وورطت البلاد في الحرب العالمية الأولى، وألحقت بها الهزائم الأخيرة؛ فإن دولة العدالة والتنمية قد نأت بنفسها عن أي صراع، واختط مهندسها الإستراتيجي أحمد داود أوغلو سياسة «تصفير المشكلات» في المنطقة لتوفير الجهد والمال لإعادة بناء تركيا ونموها، تلك السياسة التي بدا أنها مؤقتة ريثما يشتد عود الدولة، فلا تسرف في الدخول في دوائر مهلكة قبل الجاهزية الكاملة لها، وإذا كانت مؤسسات الدولة قد أفلتت من يد السلطان؛ فإن «العثمانيين الجدد» آخذون في استردادها، وبطرق ذكية ومبدعة، وإذا كانت مظالم الأقليات وكثير من حركات التمرد قد تغذت على ضعف الدولة العثمانية وعلى افتقارها لسياسة عادلة أحيانًا، وحازمة أحيانًا أخرى؛ فإن مفتاح الحل في مباشرة سياسة عادلة في تركيا، وفي إخماد حركات التمرد بتحقيق بعض المطالب، وتنمية المناطق المهمشة، والجلوس على موائد المفاوضات من منطلقات قوة وعدالة معًا.
وفي محيطها، بل في العالم، كانت الدولة العثمانية في أواخر عمرها قد غرقت في فوضى سياسية وتحالفات وسياسات لم تدعها كدولة «الحلم الأوربي» التي تميزت عن جيرانها برفاهية وقوة، وقبل ذلك بقيم عادلة، نجحت في أول عهدها وفتوحاتها في أن تنشر الدين عبر تقديم المثال الرائع الذي افتقرت إليه أوربا (لم تخسر الدولة العثمانية كل هذه حتى مع احتضارها، لكن تسلط يهود الدونمة حرفها عن مسارها كثيرًا في نهاياتها، وصارت مأخوذة إلى الغرب بانبهار في مجالات شتى).. أما ما تحاول تقديمه دولة العدالة والتنمية التركية الآن فهو ما يدعو للتأمل حقيقة، لجهة القيم والالتزام بأخلاقيات سياسية هجرتها «الحداثة الغربية» في مرحلة انسحاقها القيمي الحالي، وتراجعها المدني، إن جاز التعبير.
بعض المفكرين السياسيين أخذوا على حكومة العدالة والتنمية هذه «السياسة السلبية» تجاه محيطها الإقليمي، معتبرين أن فكرة «تصفير المشكلات» التي نظّر لها مهندس السياسة التركية، أحمد داود أوغلو ليست واقعية البتة؛ فلا يمكن لدولة تحوطها الأخطار من كل جانب أن تتخذ سياسة متصالحة مع الجميع، وأن تقف متفرجة على تغول بعض القوى في المنطقة على حساب نفوذ أنقرة، كإيران التي تمددت في الإقليم، لكن ربما ظهر لهم أو لبعضهم أن هذا النهج كان مؤقتًا لحين جهوزية تركيا للتحرك بفعالية أكبر في المنطقة الأكثر سخونة في العالم.. وقد كان.
جهوزيتها لم تكن على الصعيد الداخلي، لاسيما الاقتصادي، وإنما أيضًا على صعيد تقدير موازين القوى الخارجية، ومدى قدرتها على التحرك في الوقت المناسب، كما أنها قد ارتأت أن بناء اقتصاد قوي لا يحتاج فقط إلى «تصفير المشكلات» وعدم التورط في أحلاف أو صراعات، ولكن أيضًا هو يحتاج إلى إقامة مشروعات اقتصادية مشتركة يصعب تخلي الأطراف الأخرى عنها مستقبلًا، كخطوط الغاز والمشروعات العملاقة، والاستثمارات العقارية الضخمة.
وبتنمية اقتصادية ملائمة، وبالإفادة بشروط الانضمام الاتحاد الأوربي التي سعت إلى تطبيقها حكومة العدالة والتنمية بحذافيرها، والتي قلصت إلى حد كبير بموجب التزامها نفوذ مراكز القوى التقليدية، سواء في المناحي العسكرية أم الأمنية أم القضائية أم الاقتصادية أم الإعلامية، ارتأت أنقرة أن هذه لحظة مناسبة لكي تتجاوز حدود التعاون الاقتصادي المحدود مع دول المنطقة إلى فعالية سياسية، وشجعتها على المضي في هذه السياسة التغيرات التي طرأت على منطقة «الشرق الأوسط» أوائل هذا العقد، لكن سرعان ما جرت الريح بما لا تشتهي سفنها؛ فانقلبت تحالفاتها الجديدة نوعًا من التحدي للولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأوربا الغربية، ودول كثيرة في محيطها الإقليمي، ووجدت نفسها لأول مرة في حالة تعارض مصالح وأحيانًا صدام سياسي حاد مع دول مؤثرة في العالم والإقليم؛ فانتبهت إلى ضرورة إحداث تغيير فوري في سياستها، سواء الداخلية أو الخارجية.
فعلى الصعيد الداخلي، وجدت أن لا مجال لتأخير إجراءات التفاوض مع القوى الكردية، وعقد مباحثات داخلية هذه المرة بعد أن أفشلت بريطانيا من قبل مفاوضات حكومية - كردية جرت في أوسلو قبل نحو خمسة أعوام، وسارعت إلى تبريد الحالة العلوية المحتقنة جراء وقوف أنقرة مع الثورة السورية (السنية) ضد النظام السوري (العلوي)، ومع الزخم الذي توفر لحزب العدالة والتنمية بنجاح أردوغان كرئيس منتخب لأول مرة من الشعب التركي، وتراجع حظوظ الأحزاب المنافسة لحزبه، وشروعه في توجيه ضربة موجعة ليهود الدونمة عبر السعي لتقليل نسب ربا القروض، ونجاحه المرة تلو الأخرى في كسر عظام «الكيان الموازي» أو «الدولة العميقة»، وإجهاضه العديد من مؤامرات الانقلاب ضده، ارتأى واضعو السياسة التركية أن يقفزوا لخطوات واسعة في اتجاه «أسلمة» أو «عثمنة» تركيا، ليس لأن هذا ما يسعون إليه منذ البداية وفقًا لأجندة مبرمجة فحسب، وإنما كذلك لأنهم يدركون أكثر من أي وقت مضى أنهم مقدمون على صراع وربما حروب لن تكون إلا أيديولوجية؛ فلا يحسن دفن الرؤوس في الرمال، بل يتوجب التهيئة النفسية لها بإحياء الشعور العثماني ثم الديني للشعب التركي.
وسياسيو الحزب الحاكم ومنظروه يستوعبون جيدًا دروس الماضي، ويعلمون أن الفرص السياسية السانحة للإجهاز على القوى المعرقلة لا تتكرر كثيرًا، وأنه مثلما يكون التأني والحذر مطلوبين في ظرف؛ فإن اهتبال الفرص بسرعة لا مناص عنه في آخر، ولذا؛ فإن حكومة أنقرة سارعت إلى المضي قدمًا في سياسة «أسلمة تركيا» بوتيرة أسرع خلال تلك الفترة، لاسيما بعد إلحاقها هزيمة تلو أخرى بخصم أردوغان القوى، فتح الله كولن، الذي يمثل واجهة لقوى تقليدية عديدة، يمينية، ويسارية أيضًا! فقد ندر أن تمر إجراءات كرفع الحظر على الحجاب والسماح بارتدائه في التعليم من الصف الخامس الابتدائي إلى ما بعده في كل مراحل التعليم، وارتفاع معدلات إنشاء المدارس الدينية بوتيرة سريعة جدًا في الآونة الأخيرة، وإقرار تعليم اللغة العثمانية في المدارس، وتحفيظ القرآن في المدارس، والسماح بإنشاء تعليم غير مختلط، والتوسع في طبع المصاحف وتوزيعها من مقدونيا إلى طاجيكستان، سواء مترجمة أو بطريقة برايل للمكفوفين، ونحوها، والاهتمام باللغة العربية والاحتفاء بها، وإبداء الجانب الديني بصورة أكثر علانية ووضوحًا في الخطاب مع أوربا والكيان الصهيوني، لاسيما في موضوع القدس وانتهاكات الأقصى.. وكسر الطوق بمعدل متسارع عن «أسلمة الخطاب السياسي».. إلخ.
أما على الصعيد الخارجي؛ فلقد أدركت أنقرة أن الغرب بات موقنًا بضرورة الإطاحة بحكومة الرئيس أردوغان، لأن بروزها كقوة إقليمية متعاظمة يمكن أن يمهد لها الطريق لأن تصبح قوة عظمى لا يمكن زحزحتها عن مكانتها مستقبلًا، ويمكن أن تشجع الإقليم كله على الاحتذاء بها، خصوصًا بعد أن نسجت علاقات متينة مع قوى كانت صاعدة سواء في امتدادها العربي «العثماني» السابق، لكن مع تراجع تلك القوى أدركت أنقرة أن عليها أن تتخذ عدة تعديلات على سياستها لكيلا تدخل في بؤرة صراع إقليمي ودولي يمكن أن يسحق طموحاتها إن لم تنضج سياسة متوازنة حياله.
شعرت تركيا أن الحلف الذي تشكل لحرب «تنظيم الدولة الإسلامية»، ربما يستهدفها؛ فأجرت مناورة سياسية تكتيكية بارعة، ووضعت عربة مطلب تغيير النظام السوري أمام حصان مشاركتها في مغامرة التحالف غير المحسوبة التي قد تفتح عليها بابًا من نار الصراع مع الأكراد في كل من سوريا وتركيا والعراق، واستطاعت أن تحرج الأمريكيين والأوربيين في هذا الخصوص، ومع هذا فقد تراجعت خطوة للوراء في صراعها مع نظام بشار الأسد، وخففت قليلًا من لهجتها حيال هذا النظام فيما استمرت في احتضان اللاجئين السوريين وتوفير الرعاية لهم، بما أتاح لها فتح كوة لترطيب الأجواء مع معسكر روسيا - إيران - العراق.
ومن حسن قدرها؛ فإن التغييرات الدولية والإقليمية لم تكن جميعها ضد تركيا؛ إذ أسهمت أزمة انخفاض أسعار النفط في إنعاش الاقتصاد التركي أكثر، من جهة، ومن جهة أخرى حدا بروسيا والعراق المتضررتين من هذه النكسة الاقتصادية - إلى جوار إيران - إلى تحسين العلاقات مع تركيا؛ فكانت زيارة بوتين لتركيا برغم ما اعتراها من «مطبات» بشأن إلغاء موسكو لخط أنابيب غاز «السيل الجنوبي»، الذي كان سيمر بتركيا، وتباين وجهات النظر بشأن جلوس نشطاء «معارضين» - أو هكذا يقال - سوريين مع بشار الأسد، والتي رفضها أردوغان، إلا أن علاقة روسيا (العدو التقليدي لتركيا) قد تعززت مع التقاء مصالح البلدين الاقتصادية (باعتبار روسيا الشريك الاقتصادي الأول مع تركيا)، والسياسية في بعض الملفات، لاسيما حيال فكرة «تركيع» روسيا اقتصاديًا، والضغوط التي تمارس على روسيا من قبل الاتحاد الأوربي، الذي يتخذ موقفًا متشددًا من أنقرة، ويتخذ من مساعيها لإجهاض المحاولات التي يقوم بها الكيان الموازي للانقلاب على الديمقراطية في تركيا بمساندة إعلامية - على الأقل - من أوربا، تكأة لاتهامها بمناهضة حقوق الإنسان، والتضييق على الحريات.
العراق أيضًا، الذي شهد قبل شهور تغييرًا كبيرًا بالإطاحة برئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي تسبب بسياسته في توتير العلاقات مع تركيا وإيقاف مجلس التعاون الإستراتيجي بين تركيا والعراق، لاسيما مع استضافة تركيا لنائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي المحكوم بالإعدام، هذا البلد الجار لتركيا يجد نفسه بحاجة لتقوية علاقته بأنقرة كونه يشهد أزمة اقتصادية بسبب هبوط أسعار النفط، وفي المقابل فتركيا بحاجة إلى العراق الذي يعد ثاني أكبر سوق للصادرات التركية. ولذا فقد زار رئيس الحكومة العراقي العبادي أنقرة، والتقى نظيره التركي مستأنفًا بهذا علاقة تعرضت لاهتزاز شديد على خلفية الاضطهاد الشيعي لسنة العراق علاوة على مساندة العراق لنظام بشار، وتركيا للثوار.
مع تلك الخطوات؛ فإن حكومة الرئيس أردوغان بادرت بتعزيز اتجاهها نحو امتدادها
الإقليمي الطبيعي، شرقًا، حيث دول آسيا الوسطى، وبدا أن تركيا ماضية في تعويض علاقاتها المتوترة الآن ببعض الدول العربية، بعلاقات أخرى في دول القوقاز، وما بعد القوقاز، كتركمنستان التي شهدت تعزيزًا لافتًا للعلاقات بينها وبين تركيا، وأوزبكستان، وطاجيكستان، وقرغيزيا التي حضر رئيسها خطاب أردوغان لمناسبة نجاحه في الانتخابات الرئاسية، كبرهان على العلاقة الوثيقة التي تربط نظامه بقرغيزيا وغيرها من دول آسيا الوسطى.
لكن مع هذا؛ فإنه إذا لم يكن من الدقيق وصف أزمات تركيا الخارجية بـ«العزلة»؛ فإنه لا يمكن إنكار وقوع تركيا في أزمة حقيقية جراء توتر علاقتها مع واشنطن والعواصم الأوربية وبعض الدول العربية المؤثرة في المنطقة، وهذا النقص لا يعوضه الازدهار الاقتصادي الداخلي بتركيا، ولا التفاف الشعب حول الرئيس صاحب الكاريزما والسياسة المتميزتين، والذي سرعان مع رفع شعبيته مع مرور مئة يوم على توليه منصبه - بحسب استطلاع أجرته مؤسسة «ماك للاستشارات»، وكشف عن أن شعبية الزعيم التركي ارتفعت من 51,8 في المئة لدى نجاحه بالانتخابات إلى 70,5 في المئة خلال تلك الفترة الوجيزة.
تحاول أنقرة أن تحدث اختراقات سريعة في جدار العداء الغربي المتنامي ضدها، وهي تدرك ويدرك معها الغرب أن عبقرية الجغرافيا والتاريخ التركيين سيجعلانها في وضع لا يسمح بهزه بسهولة، لاسيما أن تركيا أضحت تملك أوراقًا أكثر من الحقبة العلمانية بكثير فيما يخص حلول مشكلات المنطقة، فهي قد صارت محور السياسة الخارجية في المنطقة، ورقمًا لا يمكن بحال لقوة عظمى أو إقليمية أن تتجاوزه أو تقفز على تطلعاته تمامًا.
-------------------------------------